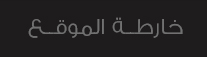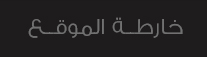|
كان من المثير أن نرى ذلك “الانقلاب” الذي أحدثته اختيارات
السيد ألبرتو باربيرا- المدير الفني لمهرجان فينيسيا السينمائي- أعرق وأهم
مهرجان سينمائي فني في العالم- لأفلام المسابقة الرسمية بوجه خاص، حيث
استبعد أفلام “الأسماء الكبيرة” وفضل الاهتمام بأفلام الأسماء الجديدة
نسبيا.
وتعتبر أفلام المسابقة عادة الأهم والأكثر إثارة لاهتمام
الصحافة والنقد، ليس فقط لكونها تتنافس على الجائزة الكبرى للمهرجان، أي
“الأسد الذهبي” وتوابعه، بل لأنها تجيز افتراض أن هذه هي خلاصة ما تلقاه
المهرجان من مئات أفلام بغرض المشاركة في التنافس.
والمقصود بـ”الانقلاب” هو غلبة التنويع والأسماء الغير
معروفة كثيرا، على الأسماء “الكبيرة” في مجال الإخراج السينمائي وهي التي
تمنح مسابقات المهرجانات الكبرى عادة قوتها ورونقها، تستقطب الاهتمام وتثير
التكهنات بشأنها. ولو توقفنا فقط أمام مثال واحد من دورة عام 1975 لأمكن أن
ندرك هذه الحقيقة.
في دورة 1975 وهي الدورة رقم 33 من المهرجان، كان هناك 27
فيلما في المسابقة الرسمية، من بينها أفلام للمخرجين التالية أسماؤهم: جان
لوك جودار، بوب فوس، فاسبندر، ستانلي كوبريك، ناجيزا أوشيما، باربيت
شرويدر، كن راسل، فولكر شلوندورف، مرجريت دوراس، لاري بيرس، مايكل ريتشي،
فرانك بيري، ميرنال سن.
اختيارات باربيرا هذا العام مزجت بين عدد من الأسماء
الكبيرة المعروفة والأسماء الجديدة نسبيا، وكانت المفاجأة أن المسابقة التي
تضمنت 21 فيلما، احتوت أفلاما أقل كثيرا من المستوى الأساسي الذي يجب توفره
في فيلم يشارك في مسابقة مهرجان دولي كبير بمستوى مهرجان فينيسيا، من هذه
الأفلام مثلا غالبية الأفلام الإيطالية المشاركة وعددها 4 أفلام، ليس من
بينها سوى فيلم واحد فقط هو فيلم المخرج المرموق باولو سورينيتنو “لا
جراتسيا” الذي يستحق المشاركة (كتبت ونشرت عنه في هذا الموقع).
وقد أخطأ باربيرا أيضا- في رأيي الشخصي- عندما ارتد إلى
المزج بين الأجناس السينمائية فاختار فيلمين تسجيليين من إيطاليا للمسابقة،
أولهما هو فيلم “تحت الغيوم” للمخرج جيان كارلو روسي، وهو عمل ضعيف على
المستوى الفني، حيث يفتقد البناء القوي المتين الذي يصوغ من خلاله قصة
واضحة، بل هو عبارة عن انطباعات حرة متفرقة عن الحياة والعمل في مدينة
نابولي من دون أي سياق يجعل أي متفرج يشعر بمتعة المتابعة في عمل بطيء
مترهل الإيقاع، شاحب الصور، يمتد لنحو ساعتين. فهل كان المطلوب المشاركة
بأكبر عدد ممكن من الأفلام الإيطالية بغض النظر عن المستوى؟
أما الفيلم التسجيلي الطويل الإيطالي الثاني فهو عما تعرض
له تصوير فيلم للمخرج الإيطالي ماريو ماريسكو من متاعب مع المنتجين أدى إلى
توقف تصويره، وهو موضوع شديد الخصوصية قد يهم أولا وأخيرا المتفرج
الإيطالي، ومما يضره الإغراق في تفاصيل غير مفيدة، بل وليس من الممكن أصلا
مساواة التسجيلي بالروائي أمام لجنة تحكيم واحدة تقوم الأفلام بناء على
معطيات واضحة، تختلف بالطبع من الروائي إلى التسجيلي.
الفيلم الإيطالي الثالث في المسابقة هو فيلم “دوس”
Duce
للمخرج بيترو مارسيللو، دراما تقليدية تماما، عن ممثلة تقدمت في العمر
لكنها تتشبث، لا تريد أن تتقاعد رغم اضطراب قوتها العقلية تدريجيا بشكل
يثير الرثاء، يشوب علاقتها التوتر والقطيعة أيضا، فالواضح أن هواجسها
الخاصة بالتمثيل وإدمان العمل على المسرح، جعلتها تهمل ابنتها طويلا،
والابنة ترثي لحال أمها وتدرك أن صحتها تدهورت ولم تعد تقدر على العمل، كما
أن دوس” تقع بسهولة في حبائل الفاشية الإيطالية بل وترحب بمقابلة مع
موسوليني، الذي يريد استخدامها كنحمة مشهورة في الدعاية للنظام.. الخ ومثل
هذا الموضوع سبق تناوله أكثر من مرة في السينما، في أفلام ربما تكون أكثر
تماسكا وأقل ترهلا واستطرادا من هذا الفيلم المبني بالطبع على شخصية حقيقية
يعرفها الإيطاليون في تاريخ المسرح في بلادهم.
الفيلم الإيطالي الرابع، “إليسا”
Elisa
للمخرج ليوناردو دي كوستانزو، فهو أيضا دراما تقليدية عن امرأة قتلت
شقيقتها وحرقت جثتها كما حاولت قتل أمها، بسبب اضطراب شخصيتها، يصيبها بنوع
من العمى والعجز عن إدراك ما تفعله بل وتفقد أيضا القدرة على تذكر أفعالها،
وكيف تواجه نفسها وتسعى لفهم حالتها بمساعدة أستاذ خبير في علم الجريمة
(يقوم بدوره الجزائري الأصل رشدي زيم)، متخصص في التحليل النفسي لشخصيات
المجرمين الذين لا يعتبرهم مجرمين بل يعتقد أن كل منا يكمن العنف والميل
للقتل في داخله. الموضوع قوي وهو شأن الفيلم السابق مقتبس عن أحداث حقيقية،
والتمثيل متميز كثيرا، وقد تنال بطلته “باربرا بونشي” جائزة التمثيل.
وإذا كان يمكن فهم وجود هذا العدد من الأفلام الإيطالية
الجديدة التي تمثل سينما عجوز أدركها الكثير من التعب والإرهاق، وأصبحت شبه
عاجزة عن تقديم مخرجين جدد متألقي الموهبة وهي التي قدمت لنا في الماضي،
وفي وقت واحد كلا من فيلليني وأنطونيوني وفيسكونتي وبازوليني وأولمي
وفرنشيسكو روزي ولينا فيرتموللر، وليليانا كافاني، وبرتولوتشي وسيرجيو
ليوني وتورناتوري، وغيرهم، فمن الصعب كثيرا أن نفهم اختيار فيلمين (مرة
واحدة) من السينما الصينية “الرسمية”، هما أقرب إلى الميلودراما
والرومانسية السطحية، كان يمكن ببساطة وضعهما خارج المسابقة، لكن يبدو أن
وجود هذين الفيلمين في المسابقة يرجع إلى هدف سياسي هو الرغبة في إبراز قوة
وحضور الصين، عن طريق إحاطة سينما الصين بالأضواء والترويج لها في هذا
المحفل السينمائي الكبير!
الاختيارات الأمريكية كانت معقولة إلى حد كبير، ومع ذلك فقد
غلبت الرغبة في جلب أكبر عدد من أسماء النجوم اللامعين على اختيار بعض
الأفلام التي وجدتها دون المستوى. كانت هناك مثلا أسماء مثل جوليا روبرتس
وجورج كلوني، وإيما ستون، وكيت بلانشيت، وإميلي بلانت، وجاكوب الرودي،
وجريتا جرويج.. إلخ.
لا يعدو فيلم جوليا روبرتس، “بعد المطاردة”
After the Hunt
الذي أحيط بضجيج كبير، سوى عمل متوسط الجودة، قد يصلح أكثر لقضاء سهرة
تليفزيونية، وربما يكون اختياره راجعا إلى أن مخرجه إيطالي وهو لوكا
جوادينينو صاحب الحظ السعيد في مهرجانات العالم رغم مستواه المتوسط بشكل
عام. وفيلمه الجديد مليء بالثرثرة والأحاديث المتعالية المليئة بالمصطلحات
الفلسفية ولغة المثقفين، كونها تدور بين حلقة من أساتذة الفلسفة في جامعة
ييل الأمريكية، بينما لا يحقق موضوعه المضطرب مبتغاه، ويظل متسما بقدر من
الغموض.
إنه يدور حول طالبة جامعية (سوداء) لا تتمتع في الحقيقة بأي
قدر من الجمال أو الجاذبية، تتهم أحد أساتذتها بالاعتداء الجنسي عليها، في
حين أنه يصر أنه بريء، والوسيط الواقع في المنتصف بين هذه الطالبة والأستاذ
المتهم، هي جوليا روبرتس وهي مدرسة في قسم الفلسفة مع ذلك المدرس المتهم.
إنها تتمتع بثقة الطالبة بل بإعجابها كونها أيضا لا تخفي ميولها الجنسية
المثلية تجاهها، وفي نفس الوقت، ترتبط “روبرتس” بعلاقة جنسية سرية مع هذا
المدرس المتهم، رغم أن زوجها يحبها كثيرا جدا. لكنها لا تتركه بل تواصل
علاقته معه وتكذب عليها، وتخفي تطلعاتها وطموحها المهني الذي يجعلها في وقت
ما، تتخذ موقف من هذه الطالبة. الزوج طبيب نفسي ناجح، لكنه يبدو متخصصا في
الطهي لجوليا وزملائها داخل المنزل أكثر من ممارسة الطب (أو أن هذا ما نراه
وما يكثر الفيلم منه في محاولة لترسيخ فكرة أن الرجل أصبح هو الذي يقوم
بالعمل التقليدي للمرأة، بينما المرأة تقوم بعمل الرجل!!).
والفيلم يناقش مشكلة الضحية: وكيف يمكن النظر إليها في
المجتمع، وهل يجب تصديق ما تقوله دائما والانحياز لصفها، وهل أخطأت
الأستاذة روبرتس عندما اتهمتها بالكذب ثم تراجعت عن ذلك بعد أن وجدت ما
يوحي بأن الرجل ربما يكون قد ارتكب ما تنسبه الطالبة إليه رغم ان لا دليل
عليه؟ وهل يتغلب سعي روبرتس للحصول على ترقية في الجامعة على الالتزام
بمعايير النزاهة والاستقامة في التقدير والحكم، وكلها أفكار نظرية يتم
التعبير عنها بالحديث والثرثرة والشرح والتبرير والتفسير والاختلاف في
الرأي.. أي أن الفيلم فقير جدا بصريا، فالضوء فيه موظف لإضفاء الجو العام
الكئيب المليء بالتشكك فقط، والمونتاج مكرس للانتقال بين الأفواه المتكلمة،
مع بيان طبيعة المكان.
لم ألحق عرض الفيلم الأمريكي “جين كيلي”
Jane Kally
للمخرج نوح بومباخ، ولم أستطع الصمود أمام الفيلم البريطاني للمخرجة
النرويجية مونا فيسفولد “وصية آن لي” فغادرت العرض بعد نحو 45 دقيقة، لذلك
لا أستطيع ان أكتب أو أقرر شيئا بشأن هذين الفيلمين. لكني شاهدت باقي
الأفلام وأهمها بالطبع فيلم “آلة التدمير”
The Smashing Machine
للمخرج “بيني صفدي” (39 سنة) الذي يطرحونه في أوساط صناعة السينما حاليا
باعتباره الموهبة المتألقة الجديدة التي ستدهش العالم.
“آلة
التدمير” فيلم “رياضي” حسب التصنيف الأمريكي، ومن أفلام سير الشخصيات، فهو
يدور حول حياة “مارك كير” المصارع السابق ومقاتل ما يعرف بـ”فنون القتال”
المختلطة المتعددة (نوع من المصارعة الحرة) الذي يقوم بدوره في الفيلم
المصارع الحقيقي أيضا (الذي تحول منذ سنوات إلى التمثيل) وهو دواين جونسون،
إلى جانب إيميلي بلانت في دور حبيبته (ثم زوجته) التي لا تشعر بالراحة أبدا
معه، وتبدو مؤرقة بل ومصابة بالعصاب، ليس خوفا عليه، بل ربما تشعر بالغيرة
من تركز الاهتمام عليه وأن دورها انحسر في عمل المنزل فقط والاهتمام به
ورعايته، بينما تشعر هي بالاحتياج والتعويض النفسي رغم أن بطلنا هذا، الذي
يمارس أقسى درجات العنف، يتمتع برقة وطيبة قلب ظاهرة تماما، ورغم
استفزازاتها المستمرة له إلا أنه لا يمد يده عليها قط،، ولكن عندما كان
يفيض به الكيل كان يكسر باب غرفة، بينما تقوم هي في سورة غضبها بتحطيم
الهدية الثمينة النادرة أو التحفة الأثرية التي اشتراها هو من اليابان
وأهداها إليها. هي متشككة، متوجسة دائما، تريد أن تكون معه في كل مكان،
تشغر بالغيرة من علاقته بأصدقائه وزملائه في لك الرياضة العنفة وتتسبب
بالتالي في هزيمته وهبوطه من بطولة العالم الى أسفل سافلين.
الفيلم يطرح تساؤلات مثل هل يستحق الأمر كل هذه المعاناة
والدمار الجسدي الذي يدفع البطل تدريجيا الى إدكان العقاقير المسكنة للألم؟
وهل كان الأمر يستحق أن يجد البطل نفسه مضطرا لممارسة هذه الرياضة أكثر في
اليابان خارج بلاده، حيث يستغل اليابانيون كيف يستغلون هذا النوع من القتال
العنيف لجني الأموال؟ وهل كان القتال أولا وأخيرا تنافسا عنيفا يضطر البطل
خلاله أيضا إلى الفتك بصديقه غن حدث ونازله على الحلبة، من أجل الحصول على
المكافأة المالية الضخمة المرصودة؟
إنها
قصة مؤثرة مصنوعة جيدا، وفيها يتألق دواين جونسون (الذي عرف باسم الصخرة)
في أداء دور يشبهه كثيرا في الواقع، بجسده الضخم وعضلاته المفتولة، وتبدو
جميع مشاهد المصارعة حقيقية تماما ومقنعة بدرجة مدهشة حقا. ربما نكون قد
شاهدنا مثيلا لها في فيلم أفضل كثيرا ويبقى في الذاكرة هو فيلم “المصارع”
The Wrestler
الذي قام ببطولته الممثل ميكي رورك وأخرجه دارين أرونوفسكي، أو فيلم “الرجل
السندريلا” لرون هاوراد الذي قام ببطولته راسل كرو وأمامه رينيه زيلويجر،
وكلاهما عرض في مسابقة مهرجان فينيسيا عامي 2005 و2008.
أما فيلم “اليتيم” للمخرج المجري لازلو نيمتس (الذي أتحفنا
قبل سنوات بفيلمه البديع “أين شاؤول”- 2015)، فجاء أقل كثيرا مما كان
متوقعا. إنه يصور محنة طفل مراهق يقدس سيرة والده الغائب منذ الحرب
العالمية الثانية، لا نعرف ما إذا كان على قيد الحياة أو مات، يرفض علاقة
أمه بجزاء بدين يبدو فظا لكن من دون لحظات من التودد والرغبة في تبني
الولد. هناك أجواء قاتمة مظللة بالألوان والإضاءة الداكنة في معظم المشاهد،
مع استخدام الحجم الخانق للشاشة، مع الإشارة إلى أصداء ما وقع في المجر في
منتصف الخمسينيات، من هزيمة الانتفاضة على الوجود السوفيتي. العمل بشكل عام
لم ينجح في الربط بين الموضوع السياسي والحالة الشخصية لطفل ينضج على ضوء
اللحظة التاريخية.
أعجبني كثيرا الجزئين: الأول والثاني- من فيلم المخرج
الأمريكي الموهوب جيم جارموش “أب أم أخ أخت”. ولكني شعرت أن جارموش أفسد
فيلمه بيده، عندما ابتعد تماما في الجزء الثالث والأخير من الفيلم، عن
الأسلوب الذي اتبعه في الجزئين الأول والثاني، ولجأ لتصوير علاقة بين شقيق
وشقيقة (من الأمريكيين الأفارقة)، أراد من خلال قصتهما وهما يعودان الى شقة
العائلة التي نشأ كلاهما فيها في باريس، أن يتذكرا طفولتهما ثم يسترجعان ما
حل من مأساة مع وفاة الأب والأم في حادث أليم، ويتجاوزانه بالحب والذكرى.
هنا فقد الفيلم كل ما حققه من طرافة ومرح وحوار يتميز بالطرافة والدفء
وعبثية الحياة في الجزئين الأول والثاني. وفيهما يلخص جارموش في بلاغة
مدهشة، غياب الألفة بين البشر داخل العائلة الواحدة، والعجز عن العثور على
الكلمات، واللجوء بالتالي إلى تكرار عبارات لا معنى لها، وإخفاء المشاعر
الحقيقية مع التظاهر الكاذب بأن كل شيء على ما يرام بينما لا يبدو الأمر
كذلك..
طبعا هنا نرى مباراة رائعة في التمثيل بين آدم درايفر وكيت
بلانشيت وشارلوت رامبلنج وفيكي كريبس وساره جرين. ويصور جارموش الفيلم
منتقلا من بلدة نائية في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة تغطيها الثلوج،
إلى دبلن في أيرلندا، إلى العاصمة الفرنسية باريس. وهي أحب الأماكن إليه
كما يقول.
هذا فيلم طريف وبسيط ومعبر، مكتوب جيدا جدا إلى حد كبير غير
أن إيقاع الفيلم ولغته وانقلاب أسلوبه كله رأسا على عقب في الجزء الثالث
الذي يدور في باريس- كما ذكرت- تسبب في هبوط الإيقاع وفقدان الحوار جاذبيته
وطرافته، وبدا أن جارموش يريد أن يختم فيلمه بنوع من التفاؤل رغم كل قبح
الواقع.
ويمكن القول إن أهم أفلام المسابقة هي تلك التي تناولت
مواضيع سياسية على نحو أو آخر، وإن كانت أهميتها لا تنبع من قوة الرسالة
السياسية- إن كانت هناك أي رسالة- بل من مستواها الفني وطريقة صياغة
الموضوع والأداء. هذه الأفلام هي “صوت هند رجب” لكوثر بن هنية وهو أفضل
وأقوى أفلامها حتى الآن منذ فيلم “شلاط تونس” (كانت أفلام “على كف عفريت،
و”الرجل الذي باع ظهره” و”بنات ألفة” أقل كثيرا مما أحاط بها من دعاية
وترويج واهتمام مهرجاني).
يأتي بعد ذلك “فرانكشتاين” لجييرمو ديلتورو، وهو عمل إبداعي
كبير بل وأفضل معالجة للرواية الشهيرة منذ نسخة عام 1931 الذي قام ببطولته
بوريس كارلوف، رغم أن بعض نقاد الغرب (ومن ينقلون عنهم بالطبع)، قد لا
يرونه كذلك.
بعد ذلك يأتي الفيلم الفرنسي البديع “في العمل”
At Work
(راجع مقالي عنه في هذا الموقع)، والفيلم الفرنسي “الغريب” عن رواية ألبير
كامي للمخرج فرانسوا أوزون وهو قد يكون المعالجة الأفضل والأكمل لهذا العمل
الصعب متفوقا على فيلم فيسكونتي عن الرواية نفسها، وربما يكون أفضل أفلام
المسابقة بعد “لا جراتسيا”
La Grazia
للعملاق سورينتينو، و”ساحر الكرملين” لأوليفييه أسايس وهو عمل جيد جدا رغم
بعض الملاحظات، و”منزل الديناميت” للمخرجة الأمريكية كاثرين بيغلو (يستحق
مقالا خاصا بالطبع) وهو عمل شجاع يناهض بقوة عودة التنافس على السباق
النووي وما يحيط عالمنا من شر مستطير قد يقع في أي لحظة.
الفيلم المجري “الصديق الصامت” للمخرج إنيكو أنيادي، عمل
تجريبي طريف، عن علاقة الإنسان بعالم النباتات، يفترض أن النباتات تسمعنا
وتفهم ما نقوله بل وتتحدث إلينا أيضا بلغة سرية يمكننا تسجيلها، بوسائل
علمية حديثة، ولكن الطبع الكوميدي يطغى على الفيلم وشخصياته التي تتصف
بالكاريكاتورية في الأداء، مع الانتقال المستمر بين أربعة أزمنة، وبين
الأبيض والأسود والألوان. وقد وجد هذا الفيلم أصداء قوية بين النقاد، لكنه
يتطلب صبرا وتفهما وربما أيضا، معرفة ببعض أسرار علم النبات، ولم يكن هناك
بأس من عرضه بالمسابقة بالطبع كنوع مختلف عن سائر الأفلام.
شخصيا لم أجد الفيلم الكوري الجنوبي لبارك تشان ووك- “لا
يوجد اختيارآخر”
No Other Choice –
عملا عظيما كما رأه الكثير من نقاد أوروبا الذين ضحكوا كثيرا على كل ما
يحتويه هذا العمل المفتعل من تفاهات. فهو عن رجل متخصص في صناعة الورق، فقد
عمله بعد 25 عاما قضاها في المصنع، وأصبح يسعى للحصول على وظيفة في المجال
الذي تخصص فيه، ولكنه يفشل فيلجأ إلى قتل جميع المتقدمين معه للحصول على
نفس الوظيفة، وتقع مفارقات كثيرة يفترض أنها مضحكة، وعنف بالغ، وتنفجر دماء
كرتونية كثيرة، وهو ما يجده البعض طريفا ومضحكا ولم أجده كذلك، بل وجدت
أيضا أن الفيلم يكرر نفسه كثيرا، ويمتد في الزمن ويفتعل الكثير من
الالتواءات التي لا تقنع أحدا، ويمتليء بالنحيب والصراخ والهستيريا والضجيج.
عموما، الدورة شهدت الكثير من الأعمال المهمة خارج
المسابقة، وفي الأقسام الفرعية مثل أسبوع النقاد وأيام فينيسيا (أو أيام
المؤلفين). وأرجو لمن يحب- أن يراجع ما نشرته في “عين على السينما” خلال
المهرجان عن عدد من أهم ما شاهدته من الأفلام التي أعجبتني، وتجنبت الكتابة
عما لم يعجبني.
أفضل أفلام المسابقة
لا جراتسيا
الغريب
في العمل
صوت هند رجب
فرانكنشتاين
أب أم أخ أخت
بيوغونيا
ساحر الكرملين |